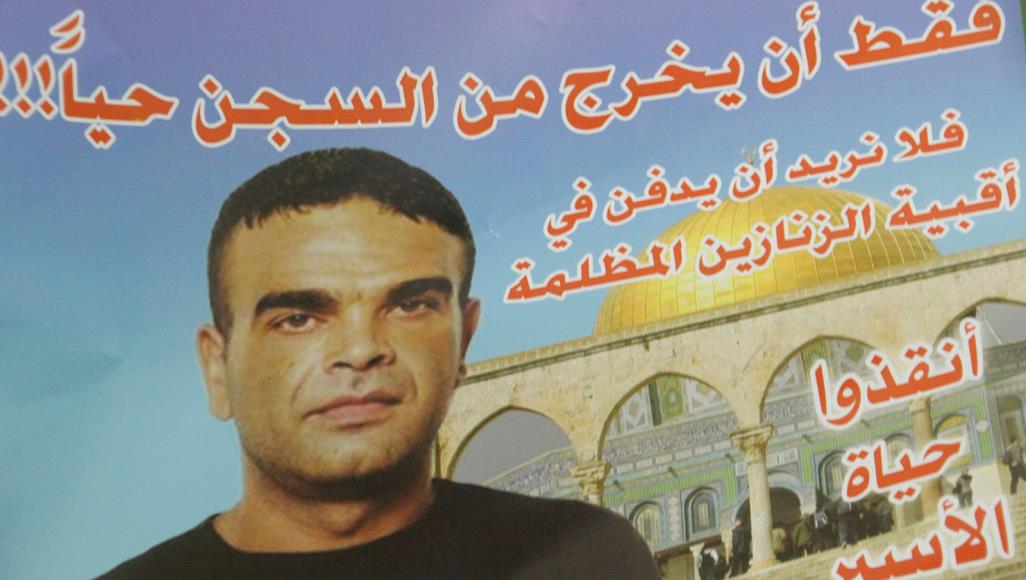حسام مطر
خصصت مجلة «فورين أفيرز» عدد تموز/ آب للتقصّي عن سؤال «في أيّ عالم نحن نعيش»؟ وتعكس الأعداد الأخيرة للمجلة، بالإضافة إلى منشورات جملة من مراكز الدراسات والمطبوعات الأميركية ذات الاتجاه الليبرالي، عمق القلق السائد على النظام الدولي الليبرالي الحالي أو ما يعرف بنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. وتسود هذه الأوساط كتابات حول أزمة الليبرالية الحالية في النظام العالمي ونقاشات حول ما إذا كانت هذه مجرد أزمة عابرة اعتادت الليبرالية على تجاوزها، أم أنها تواجه شيئاً غير مسبوق، وتالياً كيفية الاستجابة وما هي البدائل الممكنة للنظام الحالي إن كان لا بد من بديل. في الجواب عن السؤال أعلاه، تعرض «فورين أفيرز» ستة عوالم يصح القول إنها متفاعلة ومتداخلة، وغالباً متضاربة، إلا أن ما يجمعها في الغالب هي أنها تنبئ بمستقبل مقلق للبشرية.
أولاً، لدينا «العالم الواقعي: يتغيّر اللاعبون، لكن تبقى اللعبة» (ستيفان كوتكين)، وفي هذا العالم هناك قواعد موضوعية ثابتة حيث الصراع هو الأصل، والسعي للنجاة والأمن والقوة هو مراد الجميع. ويعود هذا «العالم» للصعود بعدما ظن كثيرون أن العولمة والليبرالية تجاوزت حقبة لعبة «الجيوبولتيك» وصراعات القوى الكبرى. بناءً عليه، فأحداث هذا العالم ستقودها سياسات القوى الكبرى، ولذا فإن مسار هذا القرن مرتبط إلى حد بعيد بالشكل الذي سيتخذه التنافس الصيني ــــ الأميركي.
يرى كوتكين تماثلاً بين سماح بريطانيا، مملكة التجارة الحرة، بصعود ألمانيا التوسعية في بدايات القرن العشرين، مع ما تفعله الولايات المتحدة مع الصين. بينما لدى الليبراليين حجة مضادة بأن من شأن دمج الصين في النظام الدولي أن تقوي الاتجاهات الليبرالية داخل الصين وتُشجعها على التحوّل والاندماج السلمي في النظام، في ظل قيادة الولايات المتحدة. إلا أن ما حصل، بحسب كوتكين، هو أن الصين نجحت في بناء اقتصاد سيصبح أكبر بشكل مستدام من الاقتصاد الأميركي من دون أن تصبح الصين ليبيرالية ومن دون أن تعاني من الشمولية في الوقت ذاته. وهذا ما يدفع الساسة الأميركيين إلى اتهام الصين بأنها تستغل النظام الدولي ومؤسساته من دون أن تلتزم بقيمه وشروطه.
في المقابل، وقع الغرب في الشلل الداخلي بسبب تجاهل نخبته الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعولمة في الداخل، وهي أدت إلى تفجير تناقضات داخلية وقادت إلى ظهور الشعبوية والقومية. لكن على المدى البعيد، ورغم هذه التحولات، فإن الديكتاتورية مع قوتها تبقى هشّة في حين مهما بدت الديموقراطية مثيرة للشفقة تبقى مرنة، يقول كوتكين. ثم إن السماح بصعود الصين رافقه صعود أوروبا واليابان والبرازيل والهند وآخرون، وهؤلاء يفضلون القيادة الأميركية. لكن السؤال: هل ستضرب الصين بمصالح الآخرين عرض الحائط لأنها تستطيع القيام بذلك؟ وهل ستقبل أميركا شركاء في القيادة العالمية لأنه يجب عليها ذلك؟
لا يرى الكاتب أن التاريخ قادر على أن يخبرنا شيئاً عن المستقبل (بينما الواقعيون يقولون العكس لأن التاريخ عندهم يجري بصورة دائرية)، إلا أنه يستطيع أن يخبرنا بأن المستقبل سوف يفاجئنا. لذا، ورغم عودة «الجيوبولتيك»، فإن المخرجات الإيجابية ممكنة، فالواقعية ليست محكومة باليأس، بينما في المقابل فإن منتجات الليبرالية والعولمة كالذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد والثورة الرقمية والجينية يمكن أن تحدث انقلاباً في التجارة العالمية وتشيع الفوضى في العالم بشكل دراماتيكي، يخلص الكاتب.
كي لا ينفجر هذا العالم الواقعي، أربعة أمور ينبغي أن تحدث: أولاً، على الغرب أن ينجح في تعميم فوائد العولمة (عالم منفتح ومندمج) على غالبية سكانه، وثانياً أن تحافظ الصين على صعودها السلمي، وثالثاً على الولايات المتحدة أن تحقق توازناً سليماً من الردع القوي ضد الصين واستعادة الانتظام محلياً، ورابعاً أن تحدث نوعاً من معجزة تعالج قضية تايوان، يختم كوتكين.
وقع الغرب في الشلل الداخلي بسبب تجاهل نخبته الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعولمة في الداخل
ثانياً، لدينا «عالم ليبرالي: النظام المرن» (دانيال ديودني _ ج. جون إيكنبري)، وهو عالم يعاني من انتكاسات وتراجع وتحديات، «إلا إن النظام العالمي الليبرالي لا يزال متيناً بشكل ملحوظ، وهذا مرتبط بنمو أشكال الاعتماد المتبادل في مجالات متزايدة تدفع الجميع للعمل معاً وتزيد من الحاجة إلى المنظمات والترتيبات الدولية». تتعدد أزمات العالم الليبرالي، حيث وبعد عقود على اختفائها المفترض في الغرب، عادت القوى المظلمة للسياسة العالمية، أي اللاليبرالية والطغيان والقومية والحمائية ومجالات النفوذ والمطالبة بتغيير إقليم الدولة، لتؤكد نفسها. هذا التراجع العام في الديموقراطية الليبرالية حول العالم يبدو أنه من عوارض مرض النظام العالمي الليبرالي. إلا أن الكاتبين ينظران بكثير من الأمل والثقة إلى مستقبل العالم الليبرالي لأسباب عدة:
1ــ ليس محتوماً أن التاريخ سينتهي بانتصار الليبرالية، ولكن الذي لا مفر منه أن أي نظام عالمي لائق لن يكون إلا ليبرالياً. فالليبرالية «تبقى جذابة لأنها تستند الى التزام بالكرامة وحرية الأفراد». كما أنها تغني فكرة التسامح، وهو أمر ضروري في عالم يصبح متفاعلاً ومتنوعاً باطراد، لكن لا بد من تقليص انعدام المساواة بالعودة الى السياسات الديموقراطية الاجتماعية وإقرار ضرائب أكثر تقدمية والاستثمار في التعليم والبنى التحتية، فالليبرالية تحوي بذور خلاصها، يقول الكاتبان.
2- بالرغم من التحول الحالي، إلا أن اللحظات الثورية غالباً ما تفشل في إحداث تغيير مستدام، ولذا من غير الواقعي اليوم التفكير بأن سنوات محدودة من الديماغوجية القومية ستؤدي الى تراجع دراماتيكي لليبرالية.
3- بعكس السائد، الكثير من المؤسسات الدولية اليوم ليست ليبرالية بل «ويستفالية» مكرسة فقط لحل مشاكل الدول السيدة، سواء الديموقراطية أو الشمولية منها. كما أن عودة المنافسة الأيديولوجية ستدفع إلى تعزيز النظام الليبرالي وإجراء إصلاحات داخلية.
4- طالما تعافت الديموقراطية من أزمات ناتجة من تجاوزاتها الذاتية. ورغم أن مؤسسات النظام الليبرالي الدولي قد تبدو هشة أحياناً، إلا أنها لم تنشأ بالصدفة بل كمنتجات لمصالح عميقة. مثلاً بالنسبة إلى «الناتو»، لا تزال حوافز الالتزام به بالنسبة الى الولايات المتحدة أكبر من تلك للخروج منه. كما أن بعض أفعال ترامب الفعلية تدعم هذا النظام كقصف سوريا والوقوف بوجه روسيا والصين. كما أنه رغم تراجع أميركا، لا يزال الآخرون أكثر تمسكاً بهذا النظام وإصراراً على حمايته.
ويخلص الكاتبان إلى الـتأكيد على إيمانهما بأن الليبرالية تجاوزت ما هو أخطر من ترامب والقومية والشعبوية، مثل الركود العظيم والشيوعية وحرب المحاور، «والحل الحقيقي للمشاكل اليوم هو المزيد من الليبرالية». يعكس الكاتبان إيمانهما بفكرة التقدم التاريخي الليبرالية وإن حاولا الظهور بشكل أكثر تحفظاً من حتمية «نهاية التاريخ» لفوكوياما. وما بدا أنه خلاصة سهلة على شاكلة «الليبرالية هل الحل»، إلا أن مزيداً من الليبرالية كما طرحا تعني حكماً الصدام مع المكوّن الرأسمالي في التجربة الغربية، أي الصدام مع قوى السوق والمال، وهي مسألة أبعد ما تكون عن البساطة.
ثالثاً، لدينا «العالم القبلي: هوية الجماعة هي كل شيء» (آيمي تشوا) وهو عالم صاعد ومصدر قوته الأساسي أنه مرتبط بالطبيعة البشرية، فالقبلية غريزة أساسية حيث إن «البشر هم كائنات قبلية ونحن بحاجة إلى الانتماء إلى جماعات، ولهذا نحب النوادي والفرق الرياضية». عندما يتصل الناس بمجموعة ما تصبح هوياتهم مرتبطة بها بقوة أكبر». وتحيل الكاتبة إلى دراسات عملية تثبت أننا كبشر نتحيّز إدراكياً وعصبياً للجماعة التي ننتمي إليها، وهذا هو الجانب المظلم من الغريزة القبلية.
وبعكس التفاؤل الليبرالي، تذهب «تشوا» إلى أنه في السنوات الأخيرة عادت القبلية لتمزق نسيج الديموقراطيات الليبرالية في الدول المتقدمة. أميركا نفسها بدأت تختبر في السنوات الأخيرة هذه القبلية وهو ما ينعكس في ديناميات سياسية تدميرية تشبه تلك التي في الدول النامية والدول غير الغربية: صعود الحركات القومية والإثنية، وتراجع الثقة بنتائج الانتخابات والمؤسسات، وشيوع الديماغوجية والمتاجرة بالكراهية وبروز رِدّة شعبية ضد «المؤسسة» والأقليات الأجنبية، وفوق كل ذلك تحوّل الديموقراطية إلى محرك لقبلية سياسية صفرية. يحيل الكاتب هذه القبلية الصاعدة في أميركا إلى التحولات التي يعانيها الأميركيون البيض، ديموغرافياً واقتصادياً، ثم التباين الاجتماعي والطبقي المتزايد بين المناطق حيث تستحوذ «نخبة السواحل» على أغلب عوائد النمو.
وتنتقد الكاتبة المحللين وصناع القرار الأميركيين أنهم لطالما ركزوا في فهمهم للعالم على الأيديولوجيا والاقتصاد والصراعات السياسية، وتجاهلوا الهويات الأولية للجماعات، وتجاوزوا أن الهوية الأهم ليست تلك الوطنية بل الإثنية والمكانية والدينية والمذهبية والسلالية. فهويات الجماعات نادراً ما شكّلت رأي النخبة الأميركية حول الشؤون الدولية، وهذا ما أدى إلى أسوأ الإخفاقات منذ فييتنام حتى حربّي أفغانستان والعراق. ففي حرب فييتنام، لم يلتفت القادة الأميركيون إلى أن الثروة في جنوب فييتنام كانت تسيطر عليها أقلية إثنية من أصول صينية كانت الأكثر استفادة من مقاولات الجيش الأميركي وتوريداته. لم تستفق أميركا إلى هذا العامل إلا بشكل متأخر في العراق حين أدرك الجيش الأميركي أن «المجتمع العشائري يمثل الصفائح التكتونية في العراق والتي يستقر فوقها كل شيء» (الجنرال جون الآن). هذا التحوّل الأميركي ساهم في نجاح تجربة «الصحوات»، بحسب ما ترى «تشوا».
رابعاً، عادت لتتجلى نبوءات ماركس في «عالم ماركسي: ماذا تتوقع من الرأسمالية» (روبين ماغيز) حيث تتزايد في أميركا وأوروبا اللامساواة وتتراجع الأجور وتتضخم أرباح الشركات وتضمر الطبقة الوسطى وتُجوف الديموقراطية التي يجري استبدالها بحكم التكنوقراط لنخب معولمة. فرغم نهضة الغرب خلال سنوات ما بعد الحرب الثانية، إلا أن المصالح الاقتصادية لرأس المال (السوق) روّضت التنظيم السياسي للناس (الدولة) ولا تزال هذه المعضلة قائمة.
التحدي اليوم هو الوصول إلى ملامح لاقتصاد مختلط قادر على تأمين ما أنجزه العصر الذهبي. بحسب الكاتب، وهذا يستلزم تبنّي روح ماركس أي الاعتراف بأن الأسواق الرأسمالية يمكن أن تكون الترتيب الاجتماعي الأكثر ديناميكية الذي أنتج من قبل البشر. وهذه الديناميكية تعني أن تحقيق أهداف المساواة يستلزم تعديلات مؤسساتية جديدة مدعومة بأشكال جديدة من السياسات وترويض الأسواق وإعادة إحياء الديموقراطية الاجتماعية، وهذا لن يحصل بسياسات من الماضي.
خامساً، نحن نرى بزوغ «عالم التكنولوجيا: أهلاً في الثورة الرقمية» (كيفين دروم)، حيث يدخل العالم فجر الثورة الصناعية الثانية أي الثورة الرقمية والتي سيكون تأثيرها أعظم من الثورة الصناعية الأولى للقرن التاسع عشر التي سمحت بصعود طبقة وسطى مع ضغط حقيقي لأجل الديموقراطية. إلا أن هذه الثورة، بحسب الكاتب، لم تبدأ بعد، فحتى الآن هي ابتكرت ألعاباً إلكترونية أفضل، لكنها ستبدأ فعلاً حين تزداد الإنتاجية الكلية للاقتصاد العالمي. ما قد يغيّر الأمور هو مسألة الذكاء الاصطناعي والذي يتقدم بثبات، ولكن ما زلنا في مرحلة المخاض، ولنتجاوزها هناك حاجة إلى أجهزة بقوة الدماغ البشري وبرمجيات قادرة على التفكير باقتدار.
بعد عقود من الإحباط، الجانب المتعلق بالأجهزة (hardware) على وشك التحقق حيث توفَّر جهاز كومبيوتر بقوة الدماغ البشري لكن حجمه يعادل مساحة غرفة وبكلفة 200 مليون دولار ويستهلك كهرباء بكلفة 5 ملايين دولار سنوياً. أما على صعيد البرمجيات فالأمور أكثر ضبابية، ولكن العلماء (50% توقعوا ذلك) متفائلون ويعتقدون أنهم سينجزون برمجية قادرة على أداء كل المهام البشرية بحلول 2060 أو 2045. حينها ستؤدي هذه الأجهزة كل الأنشطة البشرية من كتابة الروايات إلى إجراء العمليات الجراحية بشكل أسرع وأمهر وبالدخول إلى كل أشكال المعرفة في العالم. هذه الثورة الرقمية ستكون الأعظم في تاريخ البشرية بحيث ستبدو كل التحولات الأخرى مزيفة بالمقارنة.
في كتابه «القوى العظمى في الذكاء الاصطناعي: الصين وسِليكون فالي والنظام العالمي الجديد» يشير كاي- فو لي، أحد أبرز خبراء الذكاء الاصطناعي اليوم، إلى نجاح الصين في تحويل التعاملات المالية إلى الهواتف الذكية (18 تريليون دولار سنوياً) ما سمح بمراكمة داتا هائلة أتاحت للشركات الصينية أن تصبح الأكثر قيمة في مجالات رؤية الكومبيوتر والتعرّف إلى الكلام وتركيب الكلام والترجمة الآلية والطائرات من دون طيار. «إن الداتا هي النفط الجديد، والصين هي السعودية الجديدة»، ففي ظل هذه الثورة الهائلة، تقود الصين التنفيذ وإن كانت أميركا تقود الاكتشافات، بحسب «لي».
لا بد من ثورة أخلاقية وفلسفية في النظر إلى الوجود الإنساني تُوازن ثورة التكنولوجيا الجارية
إلا أن من تحديات هذه الثورة تقلّص الوظائف المتاحة للبشر. بحسب بعض الدراسات فإن 38% من الوظائف في أميركا ستكون عرضة لخطر مرتفع بحلول 2030. وفي حال حصول ذلك سنصبح أمام خطر ثورات عنفية حول العالم. بحسب كاي- فو لي، فإن أبرز الوظائف المهددة هي الوظائف الفردية الروتينية مثل السائقين ووظائف المبيعات وخدمة العملاء وأطباء أمراض الدم وأطباء الأشعة، وهؤلاء سيجري استبدالهم تدريجياً خلال الـ15 سنة المقبلة. في المقابل ستنجو الوظائف الإبداعية لأن الذكاء الاصطناعي يستطيع التحسين وليس الإبداع.
وبناء عليه، الحوكمة المطلوبة في هذه الحالة، بحسب الكاتب، هي الأقدر على إدارة قوة الذكاء الاصطناعي لصالح أكثرية الناس. هذا الذكاء قد يكون قادراً على حلّ مشكلة التغيّر المناخي رغم تسببه بالبطالة الواسعة. سيتحول العالم نحو منافسات القوى الكبرى على صعيد الذكاء الاصطناعي، القبلية لن تعود مهمة، فالروبوت يقوم بالعمل فلِم الهويات؟ أما الديموقراطية الليبرالية فستكون أمام سؤال البطالة، والدين سيواجه أسئلة صعبة فالإنسان خلق ما هو مثله فكرياً وإبداعياً، يحاجج «دروم» (يبدو هناك خلاف حول قدرة الذكاء الاصطناعي على الإبداع). وحينها مثلاً يمكن تطوير تقنيات الدرونز في التعقب والاستهداف بما يجعل أي منظمة غير متطورة تقنياً عاجرة عن البقاء.
سادساً، نتجه نحو «عالم محتبس حرارياً: لماذا يهم التغيّر المناخي أكثر من أي شيء آخر» (جوشوا بوسبي). في هذا العالم يصبح خطر التغيّر المناخي لا يقل عن أي من المخاطر الكبرى التي تهدّد العالم والتي ستحدد شكل هذا القرن. فهذا التحدي لن يبقى تهديداً بعيد الأمد بل تهديداً يستلزم تحركاً فورياً. فمن أصل الـ17 سنة الأكثر سخونة ضمن السنوات المسجلة، حصلت 16 منها بعد عام 2001. لقد ازدادت حرارة سطح الأرض 1.2 Celsius منذ الثورة الصناعية، فيما هناك إجماع علمي على أن الحد الأقصى للزيادة قبل أن يحدث تغيّر مناخي خطير هو درجتان فقط، وهذا يعني أن أمام العالم 20 عاماً قبل تجاوز العتبة. في حال تحقق ذلك يعني أننا سننتقل إلى عالم من الكوارث الطبيعية وهو ما سيترك تأثيرات جيوجوليتكية مخيفة ويطلق شرارة للاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية. وهذه كلها ستختبر النظام الدولي بطرق جديدة وغير متوقعة، يشدد الكاتب.
فبسبب التغيّر المناخي ستصبح أجزاء أساسية من العالم غير قابلة للحياة ما يعني حركة هائلة للانتقال البشري واللجوء، ما سيجعل من بعض التوترات الدولية أكثر شراسة وحِدّة مثل حروب الماء والسدود (نهر الهند – نهر النيل) والجفاف وتراجع المحاصيل (في الـ25 سنة الأخيرة اختفى في الصين 28,000 نهر). كذلك أجج ذوبان مناطق قطبية التنافس على المناطق الجديدة لاستكشاف مخزونات الطاقة والممرات الجديدة، وتتزايد التوترات حول الدعم الذي تقدمه حكومات لقطاعات مرتبطة بالاقتصاد الأخضر مثل دعم الصين لصناعة الطاقة الشمسية ما دفع أميركا لفرض تعريفات عليها. كثير من سياسات الاستجابة لظاهرة تغيّر المناخ ستُنتج خاسرين ورابحين وبالتالي توترات وصراعات.
هذا التحدي، بحسب «بوسبي»، يسلتزم مستويات غير مسبوقة من التعاون العالمي لا سيما في الصين والولايات المتحدة، فدورهما مركزي في الاستجابة لتحدي تغيّر المناخ (كلاهما مسؤول عن 40% من الانبعاثات) وعليهما بناء نظام يسمح لهما بالتعاون في القضايا حيث مصيرهما مترابط مع تجاوز تنافسات الأمن الإقليمي بينهما في آسيا. ولتحقيق هذا النظام يجب الاعتراف بظاهرة تشظي القوة حيث تتخلى أميركا عن السيطرة كقوة هيمنة وتقبل بصعود الصين، وكل ذلك يوجب التعاون مع الحكومات والشركات والمجتمع المدني والأفراد الأثرياء جداً.
وفي هذا السياق، يؤكد عدد حديث لمجلة الـ«إيكونوميست» (أيار 2018) هذه التوقعات الكارثية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي ستشهد مزيداً من تراجع كميات المتساقطات وموجات الحر والعواصف الرملية من الرباط إلى طهران. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في المنطقة بضعف المعدل العالمي. وبحسب المقياس العالمي للرطوبة والحرارة فإنها ستزداد حتى عام 2100 بشكل يجعل منطقة الخليج غير قابلة للسكن. فيما كشفت الأقمار الصناعية لـ«ناسا» أن نهري دجلة والفرات خسرا من المياه العذبة بين عامي 2003- 2010 ما يوازي كمية المياه في البحر الميت، وأغلب ذلك بسبب الضخ وحفر الآبار لتعويض النقص في الأمطار.
تضع هذه التحولات المناخية ضغوطاً هائلة على الدول والمجتمعات، وفيما تنفق الدول الغنية عشرات المليارات للتكيّف وإيجاد الحلول واستيعاب الخسائر (كلفة الأحداث الطارئة المرتبطة بالطقس كلفت الولايات المتحدة 300 مليار دولار عام 2017)، تقف الدول الفقيرة وتلك الفاشلة ساكنة وعاجزة في انتظار الكارثة المميتة.
خاتمة
أربعة من أصل ستة عوالم جرى عرضها، تقدم صورة سوداوية للمستقبل المنظور، فيما يتخبط العالم الليبرالي ويتأرجح العالم التكنولوجي بين وعوده وعواقبه. فالقرن الحادي والعشرون سيتشكّل تحت وطأة ضغوط من جملة اتجاهات وتحولات هائلة مثل صعود الصين واختلال النظام العالمي، وتزايد القبلية السياسية، وتضعضع الفكرة الليبرالية سواء في النظام الدولي أو الديموقراطيات الوطنية، والاحتباس الحراري، والبطالة المرتبطة بالتكنولوجيا وكذلك العوارض الثقافية الناتجة عنها. العوالم الواقعية والقبلية والمحتبسة حرارياً هي إلى حد بعيد عالم واحد بأوجه مختلفة، عالم يعزز الميل للحرب والتنافس والصراع والمصالح الذاتية الضيقة والألعاب الصفرية والفوضى العالمية، ويتعزز كل ذلك بإخفاقات العالم الليبرالي والعوارض السلبية للعالم التكنولوجي.
الثورة التكنولوجية الجارية، لا سيما المتعلقة بالداتا، تعزز من احتكار القوة وقدرات السيطرة أقلها قبل أن يتأقلم الأضعف معها، وكذلك تُعمّق الفوارق الهائلة بين شمال العالم وجنوبه (على سبيل المثال، حالياً تتلف أوروبا سنوياً 50 مليون طن من الفاكهة والخضر نظراً إلى أن شكلها سيئ، فيما يموت 3 ملايين شخص جوعاً في دول الجنوب)، والتي بدأت تتوسع في الشمال نفسه.
يلفت «لي» إلى أن الخطر الأكبر في ثورة الذكاء الاصطناعي ليس فقدان الوظائف بل فقدان المعنى. فالثورة الصناعية غسلت أدمغتنا وجرى إقناعنا أن العمل هو سبب وجودنا وهو ما يحدد معنى حياتنا. إلا أن «لي» اكتشف، بعد تجربة الإصابة بمرض السرطان والشفاء منه، أننا «موجودون من أجل الحب… وهذا ما يميزنا عن الذكاء الاصطناعي… فنحن نتميز بالإبداع ثم الرحمة والحب والتعاطف». هنا يصبح لخسارة الوظائف الروتينية بسبب ثورة الذكاء الاصطناعي وجه آخر، ألا وهو إمكانية خلق وظائف جديدة، وظائف قائمة على التعاطف (مثل المعلمين، ومقدمي الرعاية الطبية، والأخصائيين الاجتماعيين)، أي أن نجعل من الحب مهناً (مثل التعليم المنزلي ومرافقة العجائز) وهكذا نتذكر ما يجعلنا بشراً، يقول «لي». باختصار، لا بد من «ثورة مضادة» تُوازن ثورة التكنولوجيا الجارية، ثورة أخلاقية وفلسفية في النظر إلى الوجود الإنساني على هذا الكوكب، قبل فوات الأوان، إن لم يكن قد فات.
* كاتب لبناني